بعدما خصصنا الجزء الأول لمناقشة النصوص الموظفة من طرف الجهاديين، وعرجنا على أزمة العقل الجمهوري الفرنسي، نحاول في هذا الجزء الثالث الأخير من الحوار أن نفكّر مع محمد هاشمي، أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة محمد الخامس بالرباط سابقا، بخصوص الإيمان والتفكير والعلاقة بين القلب والعقل والتصدّع الموجود بين مذهبي العلمانية والديانية وكيف يمكن أن تتم ترجمة الخلافات في ثوب “وفاق عمومي”.
هاشمي وضّح بخصوص النقطة الأولى أن “الإيمان لا يتعارض مع الفهم المعقول للعالم، ومع ذلك فهو يفسح هامشا للاعتقاد والحوار الدقيق والمتزن الذي يسمح بتطوير المعرفة والإيمان في الوقت نفسه، لهذا علينا فقط أن نخرج من فكرة الإيمان كعماء معرفي إلى الإيمان كجهد استبانة لا يتوقف، مستحضرين الآية الكريمة التي تسجل قلق الإنسان حيال ثبات وتعالي الذات الإلهية “… قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي”. إن النظر إلى الإيمان كجهد مستمر لتحقيق طمأنينة المعرفة، هو ما يمكنه أن يخلصنا من تصور الإيمان كانتحار للمعرفة”.
وأفاد ضيف هسبريس بأن الديانيين والعلمانيين يمكن أن يخدموا المنظومة القيمية المشتركة نفسها خارج أي علاقة صراعية، حين سيلتزم الدياني بحرية الاعتقاد حينما سيجد لا محالة في نصوصه الدينية ما يسمح بذلك، وستخدم حيادية الدولة العلمانية هذه الحرية في الاتجاهين، التدين أو عدم التدين، من خلال قوانين مُحكمة وليست فقط حاكمة، مبرزاً أنه “هنا سيعيش الجميع في ظل احترام متبادل بعيدا عن المزايدات، ومحاولة النقض المتبادلة، والسجال الخصامي الاعتيادي بين الطرفين”.
نص الحوار:
تحدثت عن الصّدام بين مذهبي العلمانيّة والديانيّة، واعتبرت أن كلا منهما يمكن أن يصبح اجتثاثيا للآخر بما أنها مجرد آراء وليست حقائق موضوعية.. كيف يمكننا مثلا المراهنة على العقل العمومي للمصالحة بين “المذهبين” من وجهة نظر العدالة كما نظّر لها جون رولز؟
في ظني، إن المشكل الأساس في هذا التوتر يكمن في عبارة “مجرد رأي”. إن الاعتقاد بأن الرأي هو وضعية معرفية أقل قيمة ومصداقية وأهمية من الفكرة هو مرة أخرى تقليد فرنسي، مثلته الديكارتية والتيار العقلاني الذي نجم عنه؛ إذ دافع صاحب التأملات الميتافزيقية على المرجعية النموذجية لأفكار فطرية سابقة عن الانطباعات، وهي بذور وأنوار إلهية في العقل الإنساني. ومن هنا تسمية عصر الأنوار. هذه النماذج الواضحة والمتميزة هي المعيار المرجعي الذي ينبغي أن يعتمد معرفيّا لعدم الوقوع في الخطأ، الذي لا علاقة له حسب ديكارت بحدود في العقل، وإنما بسوء استعماله حينما تتدخل الإرادة في التشويش على حالة الوضوح والتميز، وتَحِيد عن الالتزام بالأحكام القائمة عن المنهج القويم، أو الطريق السليم، الذي وضع ديكارت قواعده في غير ما كتاب من كتبه. في مقابل ذلك، تعامل فيلسوف الكوجيطو الشهير مع انفعالات النفس بالكثير من الحذر بل والازدراء، فهي بالنسبة له نتاج الحركة الحيوانية في الجسم، وبالتالي لا ترقى إلى مستوى الفكرة التي تتولد عن الطبيعة غير الممتدة للإنسان باعتباره جوهرا مفكراً. ولقد عمد ديكارت إلى وضع صنافة أساسية لهذه الانفعالات مختزلا إياها بالكثير من الحذق الفلسفي إلى ستة انفعالات أساسية: الإعجاب والحب والكراهية والرغبة والفرح والحزن. ومن خلال هذه الانفعالات الأساسية تتشكل توليفات كل الانفعالات الإنسانية الأخرى، التي ينبغي أن تخضع جميعها، نظرا لطبيعتها الحيوانية الأصلية، إلى الضبط الفكري.
هذا التقليد في الواقع يشكل خطرا على مستوى الفلسفة العملية، وكل ما يتعلق بالفعل الإنساني؛ ذلك لأن السياسة والدين هما من حيث المبدأ أرض الانفعالات والرغبات، وما يراه التقليد العقلاني الفرنسي مجرد زوائد هو في الواقع موضوع السياسة والدين الأولي الأساسي. وإذا انطلقنا من المقدمات السابقة فلا محالة أننا سنرسخ بوضوح وصاية الفكري والعقلاني، ولا أقصد المعقول، على العاطفي والانفعالي داخل هذا التوجه. وبالتالي سيكون الحكم المعرفي في هذا المجال حاسما لا هامش فيه للممكن والمحتمل والجائز. هذه الوصاية تؤسس بشكل ما لتراتبية بين أنظمة التسويغ المختلفة. وبهذا حتى حينما يسمح العقل الجمهوري بنوع من الحرية الدينية والتعددية في ممارسة الشعائر، فهو يفعل ذلك بنوع من الأبوية، دعنا نقول بسلطوية العقل الاستدلالي (la raison raisonnante) المهيمن على كل أنماط وتصورات العالم غير الموضوعية، أي ما عبرت عنه في سؤالك بصيغة “ليست موضوعية”، ولا بد أنك بقولك هذا تمثل امتدادا لعوائد اللغة الفرنسية منذ أطروحات أوغيست كونط الشهيرة عن أدوار المعرفة الإنسانية.
لكن ليس مطلوباً منا كلّنا أن نقبل بوصاية العقل الاستدلالي على بقية العقول؟
أجل، لكن هذا ينتهي بنا إلى القبول شبه التلقائي بهذه الوصاية، خصوصاً على الفكر الحدسي أو المعياري الذي هو نمط تفكير الرجل البسيط، الذي يملك آراءً واعتقادات لكنه لا يملك أفكاراً مجردة ولا مفاهيم مركبة بشكل استدلالي احترافي، فهذه أمور يجيدها رجال الدولة المتعلمون على منوال النخب التي ينتجها معهد الدراسات السياسية “sciences po”، إنهم الإكليريوس العلماني الجديد. وحينما تسمع تصريحات هؤلاء، فإنك تشعر بقشعريرة اندهاش حيال نبرة الحسم والوثوقية والأبوية التي يتحدثون بها عن كل مجريات العالم وارتباطاتها الدينية. هناك إذن في هذه الصورة الرسمية كنيسة افتراضية ذات سلطة على باقي الكنائس هي “كنيسة العقل”، في مقابل ذلك كانت الفلسفة الأنجلوسكسونية منذ توماس هوبس، الذي كان يدعوه ديكارت في الردود “الإنجليزي” بدون صفة فيلسوف، تتبنى حداثة سياسية وعلاقة مختلفة حيال تقاطع الديني والسياسي، لأنها على خلاف ديكارت أسست لتصور يضع في الاعتبار الانفعالات والانطباعات كمادة أساسية للفكر ومن ثمة للعقل. ومن هنا، فكل الأفكار تتأصل في الانطاباعات، بل إن المدرسة الاسكتلندية مع ديفيد هيوم ستفكك مبدأ العلية ذاته، وتنقله من مستوى الضرورة والكونية إلى مستوى الاحتمالية القائمة على التكرار. ومن هنا، إن التفسير الواحد يصبح بشكل ما ممتنعاً نظريا من الأساس، أضف إلى هذا أن فكرة التسامح التي كان لوك رائدها في الفكر الغربي لم تحسم أمر الكنيسة الأفضل، بل أثبتت أن أمور الاعتقاد لا يمكن الحسم فيها، وبالتالي فمن الضروري تعايش الكنائس، أي تصورات العالم، مع بعضها بعض.
لا سلطة إذن إلا من خلال وكالة أو تفويض مشروط لحكومة مدنية، متعايشة مع رمزية الكنيسة ورمزية الملك، في الواقع هذه العناصر هي ما جعل فكرة العقل العمومي ممكنة في فلسفة جون رولز الذي علمني شخصيا كيف تصبح الفلسفة درسا في التواضع والتفهم وقبول التعدد ونحت المفاهيم التي تسهل التوافقات الكبرى داخل مجتمعات تعاونية لا يفرض فيها أحد وصايته على أحد. إن فرضية العقل حينما تُستحضر في تزامن مع الحرية تتضمن أن نتيجة التفكير لا يمكن أن تكون واحدة، وأن تصورات العالم ستظلّ دائما وجهات نظر من المفترض أن نقوم بتجويدها من خلال الحوار، وليس عبر سحر وسلطة منهج دون آخر. ولهذا فالتعددية في هذه الحالة لا تصبح مجرد اعتراف بإمكانية وجود تصورات قاصرة ينبغي تأطيرها أبويا إلى غاية أن تنضج، بل تضحى تعددية إبستمولوجية، تتضمن إمكانية تبرير القيم الإنسانية الكبرى نفسها بأنماط تفكير مختلفة، بشرط أن يجري هذا التبرير في إطار علاقة حوارية تعاونية، وفي هذه الحالة نخرج من معضلة الاختيار بين الديانية والعلمانية، إلى مستوى التوافق التقاطعي إن صح ذلك ترجمة لمصطلح “overlapping consensus” الذي يعتبر هو بوصلة توفّق العقل العمومي في خلق التوازنات المدنية داخل المجتمعات التعاونية.
ألن يقتضي الأمر من الديانيين والعلمانيين أن يخدموا المنظومة القيمية المشتركة نفسها خارج أي علاقة صراعية؟
سيحدث ذلك حين سيلتزم الدياني بحرية الاعتقاد حينما سيجد لا محالة في نصوصه الدينية ما يسمح بذلك، وستخدم حيادية الدولة العلمانية هذه الحرية في الاتجاهين، التدين أو عدم التدين، من خلال قوانين مُحكمة وليست فقط حاكمة، وهنا سيعيش الجميع في ظل احترام متبادل بعيدا عن المزايدات، ومحاولة النقض المتبادلة، والسجال الخصامي الاعتيادي بين الطرفين. هذا التوافق نفسه يمكن نقله نحو العقود المبرمة مع الدول غير الليبرالية، حيث يقبل العقل العمومي على مستوى العلاقات الدولية بوجود ثقافات أخرى لا تعادي بالضرورة القيم الأخلاقية العليا ولا الحقوق الأساسية، لكنها توجد خارج سياق التجربة التاريخية للثورات الثلاث الكبرى التي تولدت عنها المجتمعات الليبرالية الغربية، وهذا يعطيها الحق في أن تبني توافقا مع البلدان الأخرى على أساس عقد أبسط، لا يلزمها ضرورة بحريات لم تنضج ظروفها الخاصة لتبنيها مباشرة، لكنها تضمنها بشكل غير مباشر وفي حدود معقولة من خلال التزامها بما هو أساسي من الحقوق الضرورية لبناء مجتمع إنساني تعاوني.
باختصار، إن هذه النقلة من هيمنة العقل الجمهوري إلى تجربة العقل العمومي التوافقي هي ما مثل هاجسي المعرفي والأكاديمي المتواضع.
بخصوص هذه المسألة، لو حاولنا اعتمادها في محيطنا التداولي، أي الإسلامي، هل هناك من أرضية تبدو لكَ مُمكنة لتساهم في ربط الوشائج بين خطابين “متناحرين” نظريّا حتى اليوم؟
مرة أخرى، أعتقد أن مسألة العلمانية من حيث هي التحييد الكامل للدولة حيال المضامين الدينية، مثلما حدده قانون 1905 وذلك بعد مخاض طويل عاشته فرنسا وهي تواجه توابع مقدماتها الأنوارية المختلفة، التي بالمناسبة لا تتضمن كلها هذا الموقف الحيادي للدولة، فهناك قراءات مسيحية متعددة لكيفية تنزيل البعد الإنساني الوضعي للتشريعات بعيدا عن الفصل الكامل للكنسية عن الدولة، إذ إن الطابع الكاثوليكي لملكية فرنسا لا يبلور كل إمكانيات الطبيعة الروحية للسلطة الجمهورية، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة التي يمكن أن نخوض فيها حول هذه القضية، لا يبدو أن الدول العربية الإسلامية مطالبة بالإجابة عن السؤال نفسه، وذلك بكل بساطة لأن العمق الديني لحياة الشعوب العربية لم يخضع أبدا لصدمة الارتداد العام مثلما حصل في فرنسا من خلال ما يدعوه إيمانويل طود “Déchristianisation”، أي الخروج من المسيحية الذي كان متضايفا مع مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي.
هذا أمر لم يحدث قط في البلدان العربية التي كان جزء منها تحت الاستعمار “الأنواري” لفرنسا، ولقد كانت إيران الشاه من أول الدول الإسلامية التي أعلنت قانونا شبيها سنة 1906، ونعلم جميعاً ردة الفعل الشعبية سنوات بعد ذلك على هذا القانون، وكيف أن ذلك أحدث نتيجة عكسية تماما، لهذا أعتقد أن سؤال العلمانية حينما يطرح في سياق شبيه كهذا على منوال الطرح الفرنسي نفسه، فإنه يكون سؤالا خارج التاريخ، بل ويضاد الحس العام لهذه البلدان، “وتراثها المشترك” حسب عبارة رينان. لهذا كل من حاول أن يعاند مسار التاريخ انتهى بفشل ذريع، بل إن الأيديولوجيات اليسارية التي قامت بسلسلة انقلابات على بعض الأنظمة الملكية في منتصف الخمسينات، سرعان ما تحولت إلى أسلمة الأيديولوجيا اليسارية نفسها، في إطار ما يدعى الاشتراكية الإسلامية، أو اليسار الإسلامي.
لهذا إن قضية الفصل في هذه الحالة مطلب غير واقعي نهائيا، اللهم في بعض الحالات ذات النسيج الديني الفصائلي المعقد مثل حالة لبنان، لكن في غيرها إن الأغلبية العظمى تنظر إلى المكون الديني كجزء أساسي من هويتها. وبالتالي لا يمكن للسياسة أن تعاند مطلبا راسخا شعبيا كهذا. في هذه الحالة ما ينبغي أن نركز عليه هو الاستقرار السيميولوجي للعلامات الدينية داخل المجال السياسي. فمن المهم ألا تُترك هذه العلامات تحت رحمة التأويلات غير المسؤولة، وهذا ما يقتضي إدخالها في إطار صلاحيات مؤسسات مختصة، ومن هنا يكون لأي شخص أن يتأول هذه العلامات بما يوافق قناعاته الخاصة في حياته الشخصية، لكن حينما يكون لذلك التأويل أثر في الحياة العامة فلا بد أن تخضع الأقلية للضوابط المؤسساتية الرسمية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، التي بالمناسبة يمكن أن نجد لها مسوغات شرعية دينية كثيرة.
كيف ذلك؟
أنت تعرف أن المجتمعات الإسلامية مرّت بعصور مزهرة وصل فيها التنوع الديني إلى أقصى الحدود، على الخصوص على مستوى النقاشات النظرية، كما عرفت طبعا حالة من القسر والقهر الديني قد نجد له نظيرا أيضا في المجتمعات الغربية، لنستحضر المرحلة الستالينية في عشرينات القرن الماضي، أو الماوية إبان الثورة الثقافية، أو الأحداث الدموية التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، إلى غير ذلك من حالات التيه والفوضى السميولوجيين، حيث يصبح لكل واحد الحق في فرض دلالته على العلامات الدينية والسياسية. وهذا يمثل حالة تضخم في التأويلات تؤدي لا محالة إلى المواجهة، وهذا ما يمكن تجنبه حينما تُحسم دلالة هذه العلامات من طرف مؤسسات تمثيلية، في هذه الحالة أيضا علينا أن نضع في الاعتبار أنه لا يوجد فقط النموذج الغربي في التمثيل السياسي والديني، بل هناك أنماط متعددة كل منها لديه ما يكفي من مبررات المعقولية لبناء الشرعية داخل جماعة معينة، هنا يصبح حياد الدولة من عدمه على المستوى الديني ليس مهما، بقدر ما يهمنا مدى قدرة التوافق العام على إقرار حالة من التساكن والتعايش تجنب المجتمعات مخاطر انفراط توازنها والدخول في تلك المواجهات الداخلية القاتلة.
هكذا إذن، إذا عرَّفنا العلمانية كوسيلة لتحقيق الوئام الاجتماعي، بغض النظر عن مدى نجاعتها، فسيكون من حقنا في مجتمعاتنا الإسلامية أن نجرب وسائل أخرى غير العلمانية، وإذا كان ثمن العلمنة هو إحداث هزة مدمرة في هذا الوفاق العام، فلن يكون من المناسب حتى أن نجرب هذا الحل الثوري، الذي جرى اعتماده في أوروبا عصر الثورات، لكن بعد ذلك أصبح الميل العام لأوروبا نفسها يتجه نحو السياسات الإصلاحية، فلماذا إذن نعتقد أننا ملزمون باللجوء إلى حل مدمر تخلى عنه حتى أولائك الذين نظَّروا له سابقا؟
قد يبدو ما تقول من الناحية النظرية مفيدا ومهما، لكن على الأرض أليس صعباً تطوير الوفاق العمومي؟
هكذا يمكن أن يبدو، لكن ذلك ممكن من خلال حسن تأطير التواصل والحوار، وضبط الحدود والصلاحيات؛ فكل ذلك قمين بأن يحقق المبتغى، بعيدا عن هوس الشعارات الصاخبة التي رفعها يوما الشارع العربي تحت تصفيق ومباركة الحكومات الغربية والمؤسسات الحقوقية التي كانت تصور الإصلاح كنوع من مسح الطاولة الراديكالي بعيدا عن كل الضوابط الهوياتية الخاصة، فكان ما كان من كارثة، بل أدى ذلك إلى الانزلاق نحو أبشع أشكال الحروب الأهلية في التاريخ. لذلك من المهم جدا أن نستحضر مدى أهمية استقرار الدولة، وحينما يراودنا حلم تفكيكها بفعل حماسة مثالية أو نظرية، من المفترض أن نزن جيدا توابع ذلك على مصيرنا ومصير الأجيال المقبلة، ولعلنا في هذا الصدد نجد أدوات مفاهيمية بالغة العمق والنجاعة في الفلسفات الجماعاتية، التي تقرأ مسألة العلمانية بشكل مختلف تماما عن الرؤية العقائدية لأتباع قانون 1905.
قلتَ إنّ “الحضور الإلهي لا يمكن أن يكون مخالفاً ومناقضاً تماماً لمبادئ العقل، وإلا سيتحوّل الدين إلى صورة سحرية غامضة، عاجزة عن بناء موقف واضح من الحياة الإنسانية وإشكالياتها”، هل يمكنك أن تفسر هذه الفكرة في ضوء خدمة أطروحة معقوليّة الدين في السّياق الإسلامي؟
كما أن هناك العلم، فهناك النزعات العلموية الضيقة التي تعتقد بوجود تصور فريد للعالم وحده يملك المصداقية والموثوقية، وفي المقابل كما هناك التصورات الدينية، فهناك الهلوسات السحرية القائمة على الخوارق والبوارق السردية، لا بد في رأيي أن نجد نقط ارتكاز أكثر توازنا ما بين التطرفين، وهذا ما يتحقق من خلال التمييز الكانطي الشهير بين ما يوجد في الحدود الشرعية للعقل وما لا يدخل ضمن حدوده، وهنا يصح أن نؤسس لتطلعات وأماني معقولة حتى وإن لم تكن عقلانية، بهذا المنطق سيصبح تصور العالم على المستوى المدني منفتحا على الضوابط المعرفية للعلم، وكذلك على المعايير الأخلاقية والاجتماعية ومن ثمة الدينية للمجتمع، وبقدر ما تتوافر المعطيات الدقيقة في مجالات الكوسمولوجيا، بقدر ما سيتغذى الفكر العام بما يتناسب مع الحالة العلمية للعصر، لكن دون أن يكون مضطرا إلى التخلي الجذري على كل سردياته الكوسموغونية “Cosmogonique”.
إن تصالح الكوسمولوجيا مع الكوسموغونيا هو نوع من التدبير الجيد للمعضلات المعرفية التي ستظل تصاحب هذا الكون باستمرار، الحال أن هذا النوع من التوفيق عاشته المجتمعات الإسلامية في ظل تيارات جريئة اعتبرت أن معقولية النقل هي بالضرورة في توافق مع معقولية العقل، وقد بدأ هذا قبل المدرسة الرشدية مع المعتزلة، الذين عبروا عن انفتاح كبير في هذا الصدد، حينما اعتبروا أن التحسين والتقبيح ليسا موقوفين على النقل، بل إن العقل نفسه قادر على أن يقبح ويحسن، بل ويؤول كل ما لا يتوافق معه، لأن فعل الخلق نفسه هو من تقدير فاعل يتصف بالعقل، الإله بهذا المعنى ليس ساحرا، بل دعنا نقول إنه مهندس، يضع نظاما من الترابطات العلية في حالة كُمون، وبالتالي فإن العالم هو سلسلة من تحقيق ما هو معقول من الأساس وإخراجه إلى حيز الفعل، فتصبح المعرفة هي ربط المعلول بعلله، وهكذا يصبح الإيمان لا يتعارض مع الفهم المعقول للعالم، ومع ذلك فهو يفسح هامشا للاعتقاد والحوار الدقيق والمتزن الذي يسمح بتطوير المعرفة والإيمان في الوقت نفسه، لهذا علينا فقط أن نخرج من فكرة الإيمان كعماء معرفي إلى الإيمان كجهد استبانة لا يتوقف، مستحضرين الآية الكريمة التي تسجل قلق الإنسان حيال ثبات وتعالي الذات الإلهية “… قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي”. إن النظر إلى الإيمان كجهد مستمر لتحقيق طمأنينة المعرفة، هو ما يمكنه أن يخلصنا من تصور الإيمان كانتحار للمعرفة.

















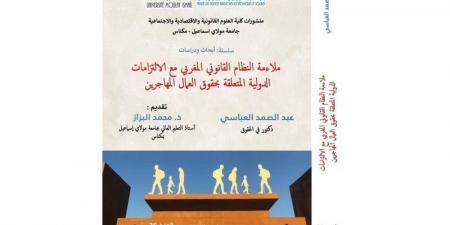

0 تعليق